تقرير اخباري: 13 أبريل 1975 ـ 13 أبريل 2021: من «حرب أهلية».. إلى «أزمة وجودية»

13 أبريل 1975 هو يوم اندلاع الحرب الأهلية في لبنان التي سميت أيضا «حرب الآخرين على أرضنا». وكل سنة تحل ذكرى الحرب كان يقال: «تنذكر وما تنعاد»، لأن اللبنانيين اكتووا بنار حرب شعواء اجتاحت شوارع عاصمتهم وأقيمت فيها خطوط تماس ومتاريس، وتمددت إلى جبالهم وقراهم وقتلت نحو 200 ألف شخص ودفعت نصف مليون لبناني إلى الهجرة.
لكن التعليق هذه السنة كان مختلفا ولسان حال أكثرية اللبنانيين يقول: «يا ما أحلى أيام الحرب»، مقارنة بالوضع الحالي الذي يواجهون فيه حربا من نوع آخر، لم يشهدوا مثلها ولا سابق لها في نتائجها المدمرة. يقول اللبنانيون ذلك بمرارة وحسرة وغضب، ووصل بهم الحال إلى أن يتحسروا و«يترحموا» على أيام الحرب التي عاشوا فيها البحبوحة والرخاء ولم ينقصهم شيء من احتياجاتهم، ولم يتعرضوا للإذلال والإهانة، ولم تصب كراماتهم ومعنوياتهم، ولم تتزعزع ثقتهم بكل شيء تقريبا، ولم يشهدوا هذا الانقطاع وهذه الهوة بينهم وبين «دولتهم وحكامهم». وهذا القلق على المستقبل والمصير.
من الـ 1975 حتى اليوم ثلاث حقب، وكل حقبة تمتد إلى 15 سنة:
الحقبة الأولى من 1975 حتى 1990
هذه الحقبة شهدت جولات من الحرب الأهلية التي دخل على خطها وبقوة ثلاثة لاعبين غير لبنانيين: الفلسطينيون والسوريون والإسرائيليون، وشهدت أحداثا جساما وتحولات جيو-سياسية و«ديمغرافية»، وانتهت عند محطة الطائف، حيث تم التوصل إلى اتفاق سياسي أدخلت بموجبه «تعديلات دستورية» ملموسة على النظام السياسي. واعتبر يوم الإعلان عن اتفاق الطائف في نوفمبر 1989 هو يوم «النهاية الرسمية» للحرب الأهلية في لبنان. ولكن سيتبين لاحقا أن الحرب استمرت بأشكال وطرق مختلفة. أبرز ما ميز هذه الحقبة «سياسيا» هو أفول عصر ما اصطلح على تسميته «المارونية السياسية» التي «حكمت لبنان» ثلاثين عاما وحتى اندلاع الحرب. وهذا التهاوي حصل بشكل متدرج وتحت ضربات متلاحقة وموجعة، بدأت مع اغتيال الرئيس بشير الجميل، وبعد ذلك حرب الجبل، وصولا إلى «حرب التحرير» التي كان اتفاق الطائف إحدى نتائجها وثمنا لوقفها. ثم حدث الانهيار والتفكك على الساحة المسيحية. «تصحرت» سياسيا: ميشال عون في المنفى وسمير جعجع في السجن. ولم يكن أمام البطريرك نصرالله صفير إلا ملء الفراغ القيادي.
الحقبة الثانية من 1990 حتى 2005
تميزت هذه الحقبة بصعود «السنية السياسية» مع الرئيس رفيق الحريري الذي حمل معه إلى رئاسة الحكومة المعززة الصلاحيات مشروعا سياسيا واقتصاديا متكاملا. وانتهت هذه الحقبة مع اغتيال الحريري الذي شكل اغتياله نكسة قوية لـ «السنية السياسية» المنبثقة عن معادلة الطائف. وكما لم ينجح الرئيس أمين الجميل في حمل وإنجاح وإكمال مشروع شقيقه، لم ينجح الرئيس سعد الحريري في حمل وإكمال مشروع والده من النقطة التي توقف عندها في «14 شباط».
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان الشرارة التي أشعلت انتفاضة 14 آذار والموقف الدولي الذي ضغط باتجاه انسحاب الجيش السوري من لبنان في ظل القرار 1559. ومع هذا الانسحاب، طويت صفحة ومرحلة امتدت ثلاثين عاما من الوجود السوري العسكري والأمني والسياسي الذي كان بالنسبة للبعض احتلالا ووصاية، وظل بالنسبة للبعض الآخر حتى آخر أيامه تواجدا حليفا وصديقا.
في حقبة ما بعد الطائف، والى جانب الصعود الممنهج للحريري و«السنية السياسية»، كان الصعود المثير لحزب الله كتنظيم مقاوم ضد إسرائيل. وحصل ذلك على مرحلتين: مرحلة التصدي للحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية وأبرزها عملية «عناقيد الغضب»، ومرحلة التحرير في العام 2000. لم يكن حزب الله موجودا في المعادلة وعلى الخارطة السياسية عندما أبرم وأعلن اتفاق
الطائف، ولم يكن الحزب من المساهمين في صنعه وهندسته، وسيظل موقفه من هذا الاتفاق ينقصه الوضوح وتحيطه إشكالية.
الحقبة الثالثة من العام 2005 حتى 2020
وهذه الحقبة تميزت بعملية خلط واسعة للأوراق، أوراق التحالفات وموازين القوى والخارطة والمعادلة. شهدت هذه الحقبة صعود «الشيعية السياسية» بقيادة حزب الله الذي عمل على ملء الفراغ السوري وإدارة اللعبة والوضع، والإمساك بزمام الأمور بدلا من السوريين، والذي اكتسب فائض قوة عسكرية وشعبية وسياسية في ضوء ثلاثة تطورات: حرب يوليو 2006 التي خرج منها منتصرا لمجرد أن إسرائيل لم تنجح في تدميره وإخضاعه. والتطور الثاني اتفاق الدوحة بعد أحداث 7 مايو الذي بدا بمثابة «ملحق» لاتفاق الطائف، وأدخل تعديلات فرعية على نصه الأساسي. وأما التطور الثالث، فهو تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون عبر تفاهم مار مخايل. هذا التحالف مكن الحزب من تحقيق أول اختراق سياسي نوعي للساحة المسيحية، ومن إحداث تغيير في ميزان القوى السياسي الداخلي، بحيث صار متكافئا بين فريقين كبيرين، وفي ظل انقسام وطني سياسي «عمودي» بين فريقي 8 و14 آذار. وبدأ هذا التوازن يختل تدريجيا تحت تأثير متغيرات داخلية وإقليمية، إلى أن بلغ الاختلال نقطة الذروة مع وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بـ «قوة الفرض» التي غلبت «قوة الرفض»، ومع حيازة حزب الله مع حلفائه على الأكثرية النيابية في انتخابات العام 2018 للمرة الأولى منذ العام 2005، ومع تشكيل حكومة اللون السياسي الواحد (حكومة حسان دياب) للمرة الأولى أيضا منذ العام 2005.
احتدم الصراع السياسي في الـ 15 سنة الأخيرة، وكان المسيحيون فيه عامل توازن وترجيح في ظل التوتر السني ـ الشيعي، وبعد عودة الطرف المسيحي بقوة إلى المعادلة بعودة عون من المنفى وخروج جعجع من السجن. أخذ هذا الصراع أشكالا دموية وعنفية مع اغتيالات وتفجيرات، وكان الأمر أقرب إلى «حرب سياسية» انتقلت فيها المتاريس من الشارع والأبنية إلى الدولة والمؤسسات.
وفي فترة وجيزة منذ سنتين تأزمت الأوضاع وتدحرجت إلى «ثورة» شعبية وأزمة كبيرة متشعبة أحدثت ما يشبه «الدمار الشامل». فحصلت انهيارات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية دراماتيكية لم يشهد لبنان مثيلا لها في تاريخه ولن يشهد. حدث زلزال قوي أطاح بكل مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويهدد لاحقا الاستقرار الأمني، وأدى إلى حدوث اختلالات واهتزازات عنيفة في كل القطاعات والمرافق، وخصوصا تلك التي كانت ميزة ومفخرة لبنان: قطاعات المصارف والمستشفيات والتعليم والسياحة والثقافة.
الأزمة لم تضرب القطاعات والبنى التحتية، ضربت أيضا المجتمع اللبناني والإنسان اللبناني. حدث انقلاب سريع في المستوى المعيشي والاجتماعي للبنانيين، فزادت نسب الفقر والعوز والبطالة والتضخم، وتراجعت نسب النمو وفرص العمل مقابل توسع حالات الصرف من العمل. تبخرت الطبقة الوسطى وتلاشت أحلام وطموحات الشباب وجيل ما بعد الحرب، لتنطلق أوسع موجة هجرة في تاريخ لبنان وأكثرها خطورة.
سبق للبنان أن شهد ومنذ العام 1975 موجات متتالية من الهجرة لأسباب أمنية «حربية»، أو لأسباب اقتصادية وضائقة مالية. ولكن هذه أول مرة يشهد هجرة ليس فقط لشباب وخريجي جامعات وإنما أيضا لأدمغة وأصحاب خبرات مكتسبة مثل الأطباء والقضاة وأساتذة الجامعات والمهندسين والفنانين و… وهذه أول مرة تكون الهجرة نهائية، ليس لأسباب أمنية واقتصادية وإنما لأسباب «وطنية» إذا صح التعبير وبدافع الخيبة والإحباط واليأس، وبسبب انهيار الثقة بالدولة وبالطبقة السياسية وبالقدرة على إنتاج حلول وإرساء وضع مستقر ومستقبل مزدهر.
جملة عوامل وظروف وأسباب متضافرة أسهمت في الوصول إلى المأزق والدخول في النفق، وفي الجنوح إلى هذه «الأزمة الوجودية». فالأزمة الراهنة هي أبعد وأعمق من أزمة حكومة وأزمة حكم وأزمة نظام، إنها أزمة وجود بكل ما للكلمة من معنى. لبنان مهدد في دوره وكيانه ووجوده، وبأن يفقد مزاياه وخصائصه و«رسالته» ويتحول إلى مجرد رقم يضاف إلى أرقام خارطة المنطقة. أما أبرز هذه العوامل والظروف:
٭ الظروف الإقليمية غير المساعدة والخارجة عن إرادة لبنان وأطرافه، وأولها حروب وأزمات الربيع العربي، وأكثرها قربا من لبنان وخطرا عليه هي الحرب السورية التي كانت أحد عوامل الاستنزاف لعافيته بسبب أعباء وكلفة النزوح والحصار والعقوبات الاقتصادية.
٭ انكفاء الدول العربية عن لبنان لأسباب عدة منها ما يتصل بانشغالاتها وأولوياتها، ومنها ما يتصل بتغير الأوضاع في لبنان بعدما أخلت سورية الساحة لإيران. وهذا ما أدى إلى حرمان لبنان من الدعم العربي ومصدر مهم للاستثمارات والأموال، في وقت كانت كل المنطقة العربية تدخل زمن الضائقة المالية والاقتصادية.
٭ تنامي قوة ونفوذ حزب الله في لبنان وقدرته على التحكم بمفاصل الدولة وقرارها، بالتوازي مع تنامي قدراته العسكرية وتحوله إلى لاعب إقليمي، وارتباطه العضوي بالمشروع الإيراني المتمدد في المنطقة، ما أدى إلى ربط الملف اللبناني بملفات وأزمات المنطقة، والى أن يكون الحل في لبنان منتظرا للحل في المنطقة، وخصوصا حل الأزمة السورية، وما أدى أيضا إلى أن يصبح لبنان جزءا من مسرح المواجهة وتصفية الحسابات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.
٭ سوء الإدارة للأوضاع والسياسات، ما أدى إلى تفاقم الأزمات وتأججها بدلا من احتوائها والتخفيف منها، ولأن يصبح «العهد» في ضائقة سياسية وشعبية. ثمة أخطاء ارتكبت بدءا من إطلاق تسمية «العهد» التي تعني حصرا رئيس الجمهورية وفريقه وتضع الآخرين خارج المسؤولية، وصولا إلى تسمية «الرئيس القوي»، بينما رئيس الجمهورية لم يعد الحلقة الأقوى في قمة السلطة. من دون إغفال مسؤولية النائب جبران باسيل في إضعاف «العهد» وإخفاقه، لأنه وضع نصب عينيه هدف الوصول إلى قصر بعبدا وأهمل مسألة إنجاح العهد وفاته أن نجاح الرئيس عون هو الطريق الأسرع لوصوله إلى قصر بعبدا، وأن فشل الرئيس عون يعني فشل مشروعه الرئاسي.
٭ الملفات والأزمات المكدسة والمتراكمة منذ ثلاثين سنة وانفجرت دفعة واحدة في وجه الرئيس عون. تضاف إليها آفة الفساد المتفشي في الجسم اللبناني. هذه الآفة التي فتكت بالمؤسسات واستنزفت الخزينة وفاقمت الدين العام وأعاقت أي تقدم وتطوير وتحديث وإصلاح.
٭ السياسات والقرارات المالية والاقتصادية الخاطئة التي عمقت الأزمة المالية وسرعت وتيرتها، وأوصلت إلى الانهيار.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأهداف سياسية وانتخابية، ومن دون تقدير دقيق للأرقام والأعباء.
ـ الهندسات المالية التي أعطت المصارف أرباحا كبيرة وسريعة، في مقابل إهمال الاقتصاد المنتج والإنفاق المجدي.
ـ التوقف عن سداد سندات اليوروبوند، وكان بمثابة إعلان غير مباشر لإفلاس الدولة وزعزعة الثقة الدولية.
٭ الحظ العاثر والسيئ عندما تتدافع أزمات وكوارث غير اعتيادية في الوقت نفسه وفي أحلك الظروف وتزيد «في الطين بلة». ويكفي أن نذكر جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
كل هذه الأسباب وغيرها أنتجت هذه الأزمة الكبرى المتشعبة والمترابطة في أسبابها السياسية والاقتصادية وفي أبعادها الإقليمية والدولية. أزمة وجودية يكافح فيها اللبنانيون للبقاء والصمود، والخروج منها سيكون مكلفا ولن يكون بطرق ووسائل ومعالجات وحلول تقليدية مألوفة.
«لبنان الماضي» الذي عرفناه وعشناه وتغنينا به.. انتهى. «لبنان الراهن» لا يشبهنا في شيء. «لبنان الجديد» لا نعرف كيف سيكون ووفق أي صيغة ونظام، وبأي كلفة ومخاض ومن ضمن أي نظام إقليمي وشرق أوسط جديد.
الأنباء


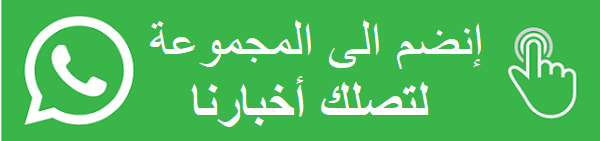
Comments are closed.